البعثة العلمية وهاجس البحث السوسيولوجي
تأسّست البعثة العلمية كمؤسسة سنة 1904 بطنجة من طرف لوشاتولير ، وقد أسند أمر تسييرها في البداية إلى جورج سالمون ، ثمّ تولّى أمر تدبيرها ابتداء من 1907 إلى شخص ذي تكوين تاريخي ( هو مؤرّخ في الأصل تحوّل بفعل التجربة الميدانية إلى باحث سوسيولوجي ) يدعى ادوار ميشوبيلير ، وينعت بأكبر العارفين بالمجتمع المغربي على حدّ قول عبد الكبير الخطيبي.
10/11/2025
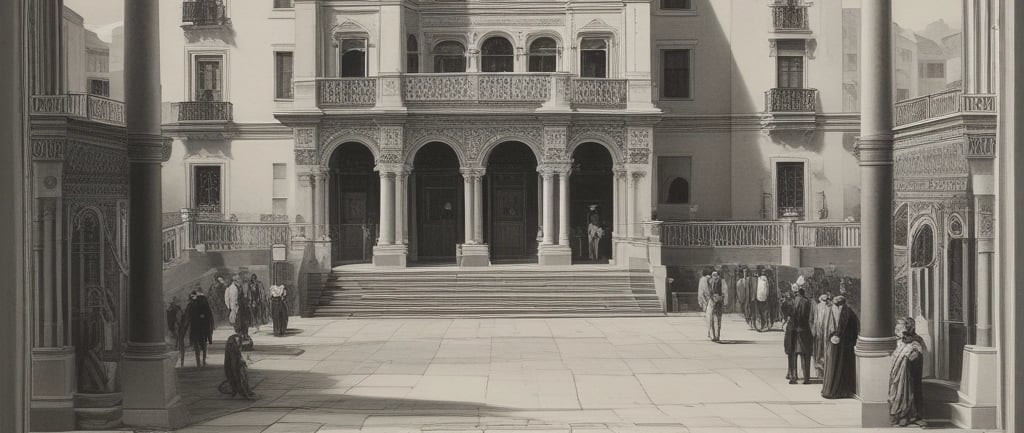
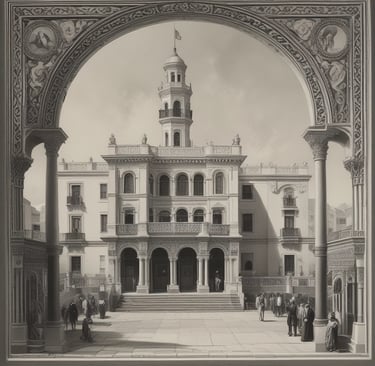
مروان العايدي – موقع علم الاجتماع
تأسّست البعثة العلمية كمؤسسة سنة 1904 بطنجة من طرف لوشاتولير ، وقد أسند أمر تسييرها في البداية إلى جورج سالمون ، ثمّ تولّى أمر تدبيرها ابتداء من 1907 إلى شخص ذي تكوين تاريخي ( هو مؤرّخ في الأصل تحوّل بفعل التجربة الميدانية إلى باحث سوسيولوجي ) يدعى ادوار ميشوبيلير ، وينعت بأكبر العارفين بالمجتمع المغربي على حدّ قول عبد الكبير الخطيبي.
ولقد جاء تأسيس البعثة العلمية على غرار تأسيس مدرسة الآداب حول المغرب العربي بالجزائر، والتي كان يتولّى إدارتها ريني باسيت بعد أقل من ثلاثين سنة. وقد جاء هذا التأسيس تعزيزا لسياسة استغلال واستعمال العلوم الاجتماعية في تنفيذ سياسة الاحتلال برؤية ومنهجية تستجيب لتجربة احتلال الجزائر، وهي سياسة كانت من إشراف وتوجيه الحاكم العام الفرنسي المقيم بالجزائر، الذي عمل على تشجيع عمليات اكتشاف المغرب ( وهي سياسة أملتها هزيمة معركة ايسلي سنة 1844 أمام الجيش الفرنسي، وهزيمة في حرب تطوان أمام الجيش الإسباني سنة 1860)، ومن نتائجها، أي السياسة، تسريع وتيرة اهتمام الباحثين الأوروبيين بالمجتمع المغربي.
فتعدّدت البعثات والرحلات للمغرب، وكان أول بحث إثنولوجي يهدف إلى معرفة عادات وطقوس المجتمع المغربي هو كتاب "المغرب المجهول" لـِ اوغست مونتاني الذي ظهر منه الجزء الأول سنة 1895 بمدينة وهران بالجزائر تحت عنوان فرعي هو "اكتشاف الريف".
وعلى الرغم من أنّ مولييرياس لم يطأ أرض الريف، على عكس الرحالة الإثنوغرافيين الآخرين الذين زاروا المغرب مثل ماكنزي ودوفوكو، فإنّ كتاب المغرب المجهول يشكّل نموذجا للدراسات الكولونيالية في تطبيقها لأدوات المعرفة الإثنوغرافية والاجتماعية عموما.
وفي نفس الاتجاه ظهرت دراسات اثنوغرافية أخرى قام بها ادموند دوتي ، الأولى "حول مراكش" والثانية "في القبيلة". كتاب "السحر والدين بإفريقيا الشمالية" ويعدّ من أكبر وأهمّ الدراسات التي أنجزت حول المعتقدات الدينية للمجتمع المغربي خلال المرحلة الاستعمارية. ولقد لعب دوتي من خلال دراساته وأبحاثه حول المجتمع المغربي، دورا في عملية انتقال فلسفة ورؤية المدرسة الكولونيالية "الجزائرية" في "مدرسة الآداب الجزائرية".
وقد أشار بول باسكون ( الجزء الثاني من أطروحته الحوز ) إلى دور دوتي في تسهيل احتلال واختراق منطقة الحوز من خلال ما قدّمه سنة 1907 للإدارة الاستعمارية من تقارير سرّية سهّلت من عملية إخضاع هذه المنطقة.
ولتقييم أبحاث إدموند دوتي الأنثروبولوجية ، ينبغي علينا وضعها داخل الإطار المعرفي للفترة التي أنجزت خلالها، وهي فترة عُرفت بهيمنة نظريات المدرسة السوسيولوجية الفرنسية والمدرسة التطوّرية البريطانية، حيث نجد صدى تطبيق هاتين النظريتين في دراسته حول المجتمع المغربي، خاصة في استعماله أو تطبيقه لمقولة الرواسب والبقايا على جميع المعتقدات والممارسات الدينية عند المغاربة، كزيارة الأضرحة وعادات التضحية والاحتفالات بعاشوراء وبو الجلود ( بتشلحيت , بولماون , بتامازيغت , بوسليخن , بالعربية , بولبطاين ...
وهِرمَة حسب دوتي، الأصل العربي بمعنى هرِم: العجوز. وقد مثّله " بوجلود " دوتي بالإلاه اليوناني هبرنيس ، وهي مقولات نابعة من النظرية التطورية بالدراسات الأنكلوساكسونية.
وتُعدّ أطروحته حول السحر والدين، المحاولة العلمية الأولى من نوعها لفهم الظواهر الثقافية والدينية للمجتمع المغربي ومجتمعات شمال إفريقيا عموما، على ضوء تطبيق النظريات العلمية السائدة وقتئذ، على الرغم من أنّ إدموند دوتي كان متحفّظا على أجرءة تلك التطبيقات وعلى نجاعتها في فهم بعض البنيات للمجتمع المغربي. كما أنّه لم يكن مطمئنّا من الخلاصات التي توصّلت إليها دراسته.ولذلك يقول : " ربّما سينتقدنا القارئ لكوننا أدمجنا في بعض الأحيان وبشكل مصطنع هذه الوقائع في إطار السوسيولوجيا المعارضة، أو لأننا اقترحنا تفسيرا غير مقنع للظواهر المدروسة ". كتاب السحر والدين في شمال إفريقيا.. أشار عبد الله حمودي أن إدموند دوتي كان على علم بأعمال مدرسة دوركهايم ، حيث كان يستعيد بوصفه وتأويله للطقوس، خاصة "طقس الذبيحة في شمال إفريقيا" ما قدّمه كل من هوبير ومارسيل موس، وكان منهجه بذلك ليس البحث عن نظرية لطقس الذبيحة "التي يجد عناصره العامّة عند هذين المؤلفين" بقدر ما كان هدفه العثور في كل أنماط الذبيحة الممارسة (الذبيحة الإسلامية) على بقايا ومخلّفات الديانات القديمة للمجتمع الأمازيغي.
ويرجع دوتي جل هذه البقايا الوثنية إلى قدرة الطقوس بشكل عام على الاستمرارية. فمعظم هذه الطقوس كانت في الأصل ذات مغزى ديني، ثم تحوّلت إلى مجرّد طقوس سحرية، ويقول في هذا الصدد: " عندما يتغيّر المعتقد، يستمرّ الطقس في الوجود، كما تبقى تلك الصدفات الأحفرية للرخويات الغابرة التي تساعدنا على تحديد الفترات الجيولوجية. فاستمرار الطقس إذن، هو سبب وجود هذه البقايا هنا وهناك" من كتابه السحر والدين.
وعلى الرغم من كون دراسات دوتي لها قيمة إثنوغرافية عالية بالنظر إلى حجم المعلومات والمعطيات التي جمعها وصنّفها، فإنّ ما آل إليه من استنتاجات وخلاصات، لم تخرج عن إطار تطبيقاته للمقولات النظرية السائدة وقتئذ، والتي اعتبرها مسلّمات لا تحتاج إلى مراجع أو تمحيص على جميع الظواهر الدينية والاجتماعية التي تناولها بالدراسة. ويشير عبد الله حمّودي أنّ المقولات النظرية التي اعتمدها دوتي كانت عناصرها مستوحاة من النظرية التطورية والمقارنة الفريزيرية.
لقد شكّلت هذه الدراسات وغيرها من التقارير إطارا معرفيا للمرحلة الاستكشافية، وبعدها جاءت الدراسات المنهجية "للمدن والقبائل" وتكوين أرشيفات، وأخيرا الأبحاث التي ستتجاوزها الإثنوغرافيا لتباشر التأويل النظري. ويشكّل تأسيس البعثة العلمية، الإطار المؤسساتي الذي ستوكل إليه تنظيم الأبحاث والدراسات حول المجتمع المغربي، وسينتج عن ذلك إصدار "الأرشيفات المغربية" و "مجلة العالم الإسلامي".
وفي سنة 1920 سيظهر أول عدد من مجلة هيسبيريس التي ستحل محل "الأرشيفات الأمازيغية" التي كانت تصدر عن المدرسة الفرنسية-الأمازيغية التي تأسست في الرباط سنة 1914.
ويشير ميشوبيلير أنّ هدف البعثة العلمية هو البحث الميداني على الوثائق التي تمكّن من دراسة المجتمع المغربي وإعادة بناء تنظيمه الاجتماعي، ليس فقط بالاعتماد على الكتب والوثائق، بل أيضا بالاعتماد على أقوال المحلّيين "الأهالي" وعاداتهم وطقوس القبائل والزوايا والأسر... "إنّها مهمّة ذات أصول سوسيولوجية".
ويضيف ميشوبيلير بخصوص تأسيس الأرشيف المغربي، أنّ ذلك يتطلب إعداد قائمة بيانات حول المجتمع المغربي، أي حول القبائل، المدن، الزوايا، حيث تمكّن هذه القائمة من البيانات من تحصيل معرفة حول الأصول والفروع والنزاعات والأحلاف، والعمل على متابعتها تاريخيا على مدار تعاقب السلالات التي حكمت المغرب، وكذلك من أجل دراسة المؤسسات والعادات ومعرفة قدر الإمكان الميدانle terrain الذي سنكون يوما مدعوين للعمل فيه.
لقد كان هدف البعثة العلمية، هو مقاربة المجتمع المغربي في وحداته وبنياته مقاربة قائمة على القرب تمكّن من إمداد الإدارة الاستعمارية وسياستها الكولونيالية من وثائق مهمّة، هذه الوثائق تمّ نشر جزء منها في الأرشيف البربري (1915-1920)، وفي موسوعة مدن وقبائل المغرب والجزء الآخر في مجلة هيسبيريس.
لقد عرفت المعرفة السوسيولوجية للمجتمع المغربي في التجربة الاستعمارية تطوّرا من الناحية التاريخية وفق ظروف التهدئة والتوغّل الاستعماري ووفق التعاقب السياسي على الإقامة العامّة. لكن يمكن القول أنه منذ تولّي جورج هاردي أمر إدارة التعليم بالمغرب مكّن من تركيز أعمال المعهد العالي للدراسات المغربية حول مجلّة هيسبيريس، هذا التوجّه أدّى إلى إدماج البعثة العلمية وشعبة السوسيولوجيا (1919) وأصبحت تابعة أساسا للإقامة العامّة.
ويمكن أن نضيف كما يقول عبد الكبير الخطيبي حول المخطط الجامعي والتعليمي لهاردي، أنّ نشاط شعبة السوسيولوجيا في هذا المعهد، خاصة المعنية بالإثنولوجيا والسوسيولوجيا المغربية، والتي كانت تحت تنسيق كل من ميرسيار وجوستينال و هوربر و الكاتب العام الذي يدعى روبير مونتاني أدّت إلى إنجاز أبحاث معمّقة حيث تمّ في إطار IHEM إعداد نسختين من الأطلس: الأولى حول القداسة Hagiographique اهتمّت أساسا بالأولياء. الثانية حول اللهجات موجّهة أساسا برؤية إثنوغرافية.
وهذا ما يفسّر كما يقول الخطيبي بأنّ فعل الإدارة الاستعمارية موجّه نحو إدارة الواقع، وأنّ هذا الواقع متعدّد اللهجات.
التفاعل
contact@melaidi.com
+212662878411
© 2025. All rights reserved.


